جلسة ليوانيّة مع كتاب مشكلة الحريّة لزكريا ابراهيم
هل الحرّيّة مناطها أن تصنع ما بدا لك؟ إن كان كذلك فإن أرادتك علىٰ نحوٍ ما لا تقدم إلا علىٰ ما هو حقيقٌ بجلب اللّذة، وتحقيق المنفعة، فهل مثلاً إرهاق نفسك علىٰ الدراسة، أو صرفها إلىٰ الكدّ والتّعب في العمل هو حرّيّة؟ نعم، ربما تقول هي حرّيّة. ولكن أخبرني ما الذي يجبرك علىٰ أن تجلب لنفسك التّعب؟ أما كان أجدىٰ بك أن تؤول إلىٰ الراحة والدّعة، فهذا منىٰ النّفس وغايتها، ورجاء أمرها، ومناط وجودها، أنّها تحبّ الكسل، وتأوي إلىٰ الراحة والسّكون. علىٰ أنّنا لا ننفي عنك اختيارك للدراسة من أجل الاختبار، أو العمل لأجل لقمة العيش الحرّيّة والإرادة، بل الحقّ كل الحقّ لك في تقرير هذا إلىٰ معنىٰ الحرّيّة. وما أودّ قوله: أن الحرّيّة متفاوتة الأثر من شخصٍ إلىٰ آخر، ومن وضعٍ إلىٰ قرينه، ومن زمانٍ إلىٰ غيره، وهكذا دواليك.
وإنّا فوق ذلك، لو أردنا مثلاً قياس أثر الحرّيّة أو شكلها ولونها وحجمها ومدىٰ تأثيرها فسنجدنا عاجزين عن ذلك قاصرين، ”فما الحرّيّة بشيءٍ يمكن تحديد وجوده، بل هي إثباتٌ للشخصيّة وتقرير وجود الإنسان، فهي ليست موضوعاً يُعاين بل هي حياة تُعانىٰ، وربما كان مَثَلُ الحرّيّة كمثل الحركة؛ فإن كلّاً منهما واقعةٌ بينه بذاتها، وليس في وسع الفكر المجرد أن يفهمها أو أن يجد لها تفسيراً منطقياً معقولاً“¹
علىٰ الأقل دعنا نعرّف الحرّيّة، وهي كما غيرها من المفردات الفلسفية والمنطقية لا تنحصر في تعريفٍ واحد، وربّما تعدّدت مفاهيمها عند كل عقلٍ وفكر، وربما اختلفت من حينٍ إلىٰ حين، ومن مذهبٍ إلىٰ آخر، ففي حين تُعرّف بناءً علىٰ الدليل الكوني لإثبات الحرّيّة: ”الحرّيّة: انعدام العلّة أو انعدام القسر“²، تُعرّف في جانبٍ آخر بناءً علىٰ التعريفي السايكولوجي لإثبات الحرّيّة: ”الحرّيّة: الاستقلال التّام عن سائر البواعث والمبرّرات.“³، والفيلسوف الفرنسي لاڤل تطّرق إلىٰ ماهيّتها إذ يقول: ”الحرّيّة ليست ظاهرة، ولا واقعة، ولا خاصية، ولا كيفية.. إن خصوم الحرّيّة يحاولون دائماً أن يعرّفوا الحرّيّة كما يعرّفوا الموضوع، ولكنها ليست موضوعاً.. وهي ليست من طبيعتنا أو جزءاً من تركيبتنا“⁴ أي أنها ليس كالعواطف والأحاسيس، مثل: الغضب، الهدوء، الحزن، الفرح، الحب.. إلخ يتطرّق زكريا ابراهيم إلىٰ قول لاڤل معقّباً فيقول: ”الحرّيّة لا يمكن أن تُدرك إلا في صميم الفعل الذي به تُمارس وجودها، فالحرّيّة إذن ليست شيئاً باطناً فينا بل هي عين وجودنا، وهي التي تسمح بخلق ذواتنا، فنحقّق بذلك مصيرنا“⁵
إن تقرير الحرّيّة للذات محمولٌ علىٰ نفس القول في نسبة الوجود إلىٰ النّفس، فكما نقول: إنني حر، نقول: إنني موجود، ونقول: أنا أفكّر إذاً أنا موجود، إذاً أنا لي الحرّيّة أن أفكّر، فأنا بذلك لي كياني الخاص، الذي لا ينفكّ عن ذاتي، فكما أنني أعملتُ عقلي في تقرير وجودي، فهذا في آن الوقت تقريرٌ لمعنىٰ الحرّيّة، أو لنقل جزءٌ من الحرّيّة: حرّيّة الفكر وتقرير الرّؤية الكامنة للنّس.ف وهو تماماً كنا ربط مارسيل بين الحرّيّة والشّعور بالذّات⁶، وصعوداً إلىٰ فكر مارسيل وفهمه للحرّيّة؛ فإنّا نراه ”يطرح كل نظريّةٍ تحاول أن تفهم الحرّيّة علىٰ ضوء الفكرة العُليا، لأنه يرىٰ أن أفدح خطأٍ يمكن أن يقع فيه الفلاسفة الباحثون في الحرّيّة؛ إنما هو التعارض الذي يضعونه بين الحرّيّة والجبريّة“⁷ أي أن مارسل لا يرىٰ أن هناك تعارضاً وتناقضاً بين الجَبر والحرّيّة، بل هما متّحدان، يُكمّل أحدهما الآخر، ويعوّل الأول نقص الثاني؛ وهذا بصفة أن الحرّيّة لا تُعرّف بتضادها مع الجبريّة، إذ أن الأولىٰ خارجة عن النفس البشرية، والثانية مطبوعةّ عليه.
وإن تعريفها حتىٰ بأي حالٍ من الأحوال ضربٌ من العنت، وشكلٌ من الإجهاد، وهو أمرٌ فيه سعةٌ في النّظر، ولا يُؤتىٰ علىٰ حقيقةٍ واحدة، إذ كما تقول مدام دي ستائل: ”حاول أن تثبت حرّيّة الإنسان فستجد أنّك لن تستطيع أن تؤمن بوجودها، ولكن ضع يدك علىٰ قلبك؛ فستجد عندئذٍ أنّك تستطيع أن تشكّ بوجودها.“⁸
وإن الرأي القائل عند النّاس بأن الحرّيّة هي نطاق مثبت، وظنّوا به أنّهم أحرار لهم في خطأ بتعريفهم لمعنىٰ الحرّيّة، وفي هذا يقول سبيونزا: ”إن الناس ليخطئون إذ يظنّون أنفسهم أحراراً. إن مرجع الناس به أنهم يشعرون بأفعالهم، وإن كانوا يجهلون العلل التي تدفعهم إلىٰ العمل“⁹، من قبيل هذا أنّك لا تُدرك نفسك ولا تشعر بها جين تحرّك قدمك اليمنىٰ قبل لليسرىٰ، ولا حين تتنفس متىٰ تشهق ومتىٰ تزفر، وكم يكون مدّة كلّ واحدةٍ من هذه العملية، ولا تستيطع أن تشعر تفسك بأنّك مسؤول عن هذا الفعل، مُدركٌ لتلك الحركة.
وربما حُمِل تعريف الحرّيّة علىٰ الرّغبة المكمونة في داخل الإنسان، يقول روسل: ”إن الحرّيّة تقتضي أن تكون إرادتنا وليدة رغباتنا، لا وليدة قوّةٍ ملزمةٍ تضطرّنا إلىٰ أن نفعل ما لسنا نريد أن نفعله“¹⁰ فالطّفل مثلاً الذي يعمل شيئاً خوفاً من العقاب؛ لا يِعتبر حراً، كذلك الشاب الذي يتعنّت جهداً في القراءة والدّراسة خوفاً من الرّسوب لا يُعتبر حرّاً، إذ اختلف الباعث؛ فبعد أن صار الدافع خارجياً انتفت عنه صفة الحرّيّة، وصار تحت الجبريّة، وحتىٰ إن كان مُريداً لهذا الفعل؛ فإن ليس باعثاً حقيقاً من داخل نفسه ورغبته الصّرفة.
عمَد بعض الفلاسفة إلىٰ نفي سلبيّة المفهوم عن الحرّيّة، وأجزأوا روح معناها إلىٰ مفاهيم مضادّةً لها، فجعلوا مقابلها الضّرورة التي تنقسم بنفسها إلىٰ معنيين؛ العَرَضيّ، والاختياريّ. ومنهم مثل اسبينوزا من جعل النّفس البشريّة مجبولةٌ علىٰ الضّرورة، مطبوعةٌ علىٰ جبريّة الاختيار بين إرادةٍ حرّة أو غيرها. وأصلها يعود إلىٰ علّةٍ مشروطةٍ بدورها بعلّةٍ أخرىٰ.. وهكذا دواليك حتىٰ تنتهي إلىٰ علّةٍ جامعةٍ شاملةٍ أوحد: الإلٰه.¹¹ هناك من دافع عن الحرّيّة في الجانب النّظري، مهملاً تأييده لها في الجانب العملي، كفولتير؛ فنرىٰ ضعف دفاعه عن حرّيّة الإرادة. فهو يرىٰ أن الإنسان يعتنق ما يعتنق ويزعم أنّه حرّ، وما ذاك إلا توهّم، فحرّيّته الموهومة تلك ضروريّةٌ للفعل، وليست أصلاً. من هذا أنّنا نبصر الرجل يُبَدّي الموت علىٰ حياة الذلّ والهوان، والنّفس كما نعلم محبّةٌ للحياة، مبغضةٌ للموت.. أوليس هذا كأنّه قد خالف إرادته، فأراد غير إرادته. وقد صار المعنىٰ: أن الإنسان يستطيع أن يعمل ما يريد، ولكنّه لا يستطيع أن يريد كما يريد!
أما لافل، فنجده مثل سبيرز، يرىٰ أن الحرّيّة ليست مُطلقة؛ لأنّه لمّا كانت الحرّيّة الإنسانيّة مجرد مشاركة؛ فإنّ لها حدوداً لا تستطيع أن تعدوها¹²، أي أنّ حرّيّتك تنتهي عند حرّيّة الآخرين. فليست هي بالمُطلقة الهوجاء المزعومة، وإلا كان استمراركَ في بعض حرّيّتك مصيبةً وجبريّةً علىٰ حرّيّة آخرين غيرك. وهو بهذا يُمهّد -لافل- لقوله: ” الضرورة والحرّيّة ليستا حدّين متعارضين بل هما حدّان متماسكانِ يُعبّران عن حقيقةٍ واحدةٍ؛ ذلك لأن العالم كلّه متماسكٌ أجزاؤه لا تستطيع أن تنهض بذاتها أو أن تكتفي بنفسها ولكنها تتمتع باستقلالٍ حقيقيٍ حينما تجيء، فتاخذ مكانها في هذا الكلّ الشّامل ومعنىٰ هذا أن الجُزء الواحد يُعاني من حيثُ هو جزء ضغطٍ علىٰ سائر الأجزاء الأخرىٰ، ولكنّه يشارك في استقلال الكلّ حينما يعمل إلىٰ الاتّحاد به، وإذن فإن الجبريّة والحرّيّة إنّما هما؛ الوجه الماديّ، والوجه الرّوحيٌ للاستقلال الذّاتيّ الّذي يُميّز الكلّ“¹³
وعلىٰ الجانب الآخر، نرىٰ مؤرّخي الماركسيّة، الّذين أطلقوا مُسمّىٰ المادّيّة التاريخيّة، وأتبعوها بالمادّيّة الجدليّة، إذ يقولون بالإيمان بالحرّيّة، ولكنّهم يعزون تلك الحرّيّة إلىٰ الإمكانيّة التي يستطيع الإنسان بمقتضاها أن يجعل قوانين الطبيعة فعّالة ومُثمرة. ولأنّ الإنسان محكومٌ بقوانينه الخاصّة التي فَرَضها علىٰ نفسه، وألزمها إيّاها؛ فبشعورهِ بتلك القوانين الخاصّة نقول: أن أن هذا الشعور هو مظهرٌ من مظاهر الحرّيّة البشريّة.
وبعد أن أنهىٰ الكاتب الباب الأول الذي أوفر في تعريف الحرّيّة والضرورة، انتقلَ إلىٰ الباب الثاني الذي أفرد فيه معاني الحتميّة: علميّها وسيكولوجيّها ولاهوتيّها. ففي علميّها؛ قوّمها البعض علىٰ أنّها إمكانيّة التنبّؤ بالأحداث الكونيّة نظراً لوجود تعاقب حتمي مُطّرد بين الظواهر الطبيعيّة.¹⁴ وهي كما عرّفها لويس دي بروي: ”إمكانيّة التنبّؤ بالظواهر تنبّؤاً دقيقاً مُحكماً“¹⁵ وأما سايكولوجيّها، فمن مذهبها كما تصدّر بعضه ديكارت إذ أنّه أول فلاسفة الذين درسوا حريّة عدم الاكتراث، وأرجعها إلىٰ صورة الإله، أنّه غير مكترثٍ. مع أنّه أرجأها في قائمة مراتب الحرّيّة إلىٰ أدناها. وقد استعمل لها مرادفة: استواء، أو الحياد العقلي. وقد قسّم الحرّيّة إلىٰ نوعين: إرادة وعدم اكتراث، أما الإرادة فهي في الغالب تكون مدفوعةً بعوامل خارجيّة؛ فهي أقرب للإنسان منها إلىٰ الإله. وأمّا عدم الاكتراث أو الاستواء؛ فهي لا تكون منوطةً بعوامل خارجيّة= لذلك رآها أقرب للإله منها إلىٰ الإنسان.
والحتميّة اللاهوتيّة.. هي مرادفٌ قريبٌ للجبريّة عندنا في الإسلام. التي يجعلها البعض رأس سنام حياة الإنسان؛ أنّه مُسيّرٌ لا مُخيّر، وأن حياته مرهونةٌ بكلمةٍ وضعها الخالق فيه فلا يحيدُ عنها إلىٰ إرادته الخاصّة. وهذا أمرٌ كما نعلم فارغ المضمون، إذ إن كان كما زعموا كذلك؛ فلا يجدر بالإله -حشاه- أن يعاقب المجرم والمذنب، إذ هم مجبولون علىٰ هذا الجرم، ليس لهم إرادة.. وهذا هو مذهب الجبريّين والقدريّين. وأمّا من زعم الحريّة الكاملة للإنسان فقد نفىٰ عن الله معرفةً له بأفعال الإنسان، فهو عندهم الله لم يخلق أفعال عباده، ولم يشأها.. هذا نراه عند الجهميّة والمعتزلة. وهناك من وقف عاجزاً عن حلّ معضلة التّسيير والتّخيير كأبي حيّانٍ التّوحيديّ. وهناك من وافىٰ بين الأمرين فقال: لا يصح أن يُقال إذا كان الله قد رأىٰ بسابق علمه أنّي سأفعل هذا الفعل أو ذاك؛ فإنّي لا محالة مُتمّمُ هذا الفعل تحقيقاً لذلك العلم، بل يجب أن يُقال: إذا كنتُ مُزمعاً أن أفعل هذا الفعل أو ذاك؛ فإن الله تعالىٰ قد عرف ذلك بسابق علمه.¹⁶
وأمّا الباب الثالث فكان حرّيّة الإرادة وإرادة الحرّيّة، ورأيتُ أنّي اكتفيت بالبابين الأوّلين، فلا داعي للإسهاب حوله.
- أبو هاشم، مُحمّدٍ بن يحيىٰ الرّفاعيّ الأُمّيّ
في أصيل يوم الثلاثاء، ذيل شهر نيسان ٢٠٢٤م
علىٰ برندة منزلي في كوتاهيا، وتحت جوّ ماطر
ــــــــــــــــــــــــ
¹: كتاب مشكلة الحريّة لزكريا ابراهيم صـ٢٢
²: نفس المصدر صـ٢٧
³: نفس المصدر صـ٢٧
⁴: نفس المصدر صـ٢٩
⁵: نفس المصدر صـ٣١
⁶: نفس المصدر صـ٣٢
⁷: نفس المصدر صـ٣٢
⁸: نفس المصدر صـ٣٤
⁹: نفس المصدر صـ٣٦
¹⁰: نفس المصدر صـ٤٦
¹¹: نفس المصدر صـ٥٤، نقلاً عن كتاب الأخلاق لاسبينوزا.
¹²: نفس المصدر صـ٦٧
¹³: نفس المصدر صـ٦٨
¹⁴: نفس المصد
ر صـ١٠١
¹⁵: نفس المصدر صـ١١٧
¹⁶: نفس المصدر صـ١٦٣
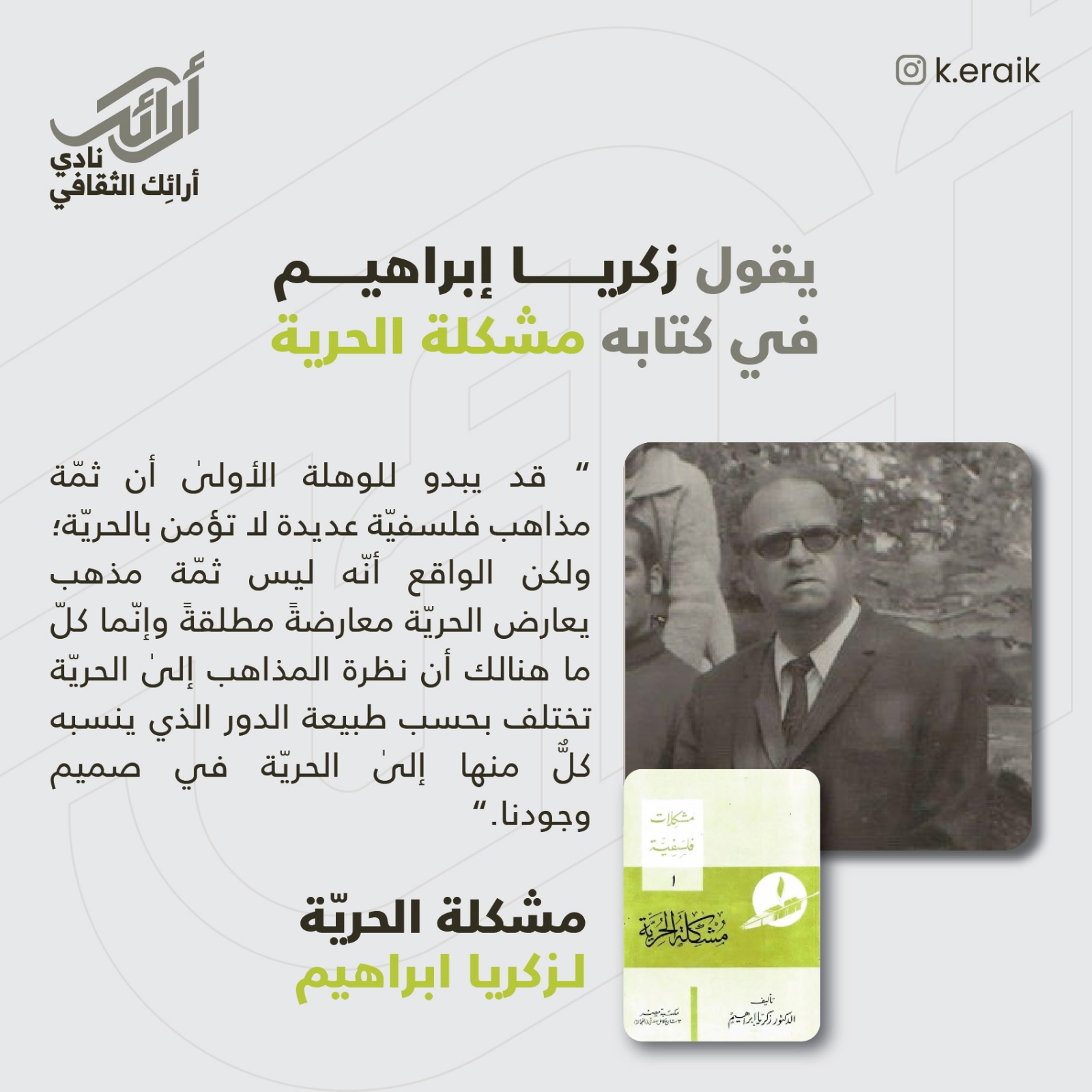



تعليقات
إرسال تعليق